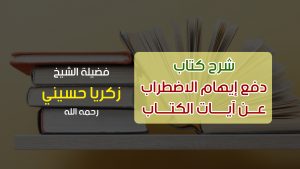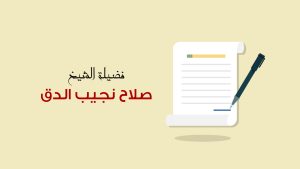الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا، والصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة وهداية للناس كافة، وعلى آله وصحابته الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
وبعد
عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما يُصَدِّقُ كلُّ واحد منهما حديث صاحبه قالا خرج رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قال النبي – صلى الله عليه وسلم – «إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعةً، فخذوا ذات اليمين» فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرًا لقريش، وسار النبي – صلى الله عليه وسلم – حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس حَلْ حَلْ فأَلَحَّتْ فقالوا خلأت القصواء، خلأت القصواء فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – «ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل» ثم قال «والذي نفسي بيده، لا يسألوني خُطةً يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» ثم زجرها فوثبتْ قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضًا، فلم يلبثه الناس، حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – العطش، فانتزع سهمًا من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالرِّيّ حتى صدروا عنه، فبينما هم كذلك إذ جاء بُدَيْلُ بن وَرْقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة – وكانوا عَيْبَةَ نُصْح رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من أهل تهامة – فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، معهم العُوذُ المطافيل وهم مقاتلوك، وصادوك عن البيت، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – «إنا لم نجيء لقتال أحد، ولكنا جئنا معتمرين، وإن قريشًا قد نَهِكَتْهُمُ الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهَرْ وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جَمُّوا وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، ولينفذن الله أمره» فقال بديل سأبلغهم ما تقول فانطلق حتى أتى قريشًا، قال إنا قد جئناكم من هذا الرجل، وسمعْناه يقول قولاً، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء قال ذوو الرأي منهم هات ما سمعته يقول قال سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي – صلى الله عليه وسلم – فقام عروة بن مسعود فقال يا قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا بلى قال ألست بالولد؟ قالوا بلى قال فهل تتهمونني؟ قالوا لا، قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، فلما بلَّحُوا عليَّ جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى قال فإن هذا عرض عليكم خطة رشد اقبلوها، ودعوني آتيه، قالوا ائته فأتاه، فجعل يكلم النبي – صلى الله عليه وسلم – ، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – نحوًا من قوله لبُدَيل فقال عروة عند ذلك أَيْ محمدُ، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، فإني والله لأرى وجوهًا، وإني لأرى أشوابًا من الناس خليقًا أن يفروا ويدعوك فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه امْصُصْ بظر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال من ذا؟ قالوا أبو بكر فقال أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أَجْزِكَ بها لأجبتك، قال وجعل يكلم النبي – صلى الله عليه وسلم – ، فكلما كلمه كلمة أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي – صلى الله عليه وسلم – ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي – صلى الله عليه وسلم – ضرب يده بنعل السيف، وقال أخر يدك عن لحية رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ، فرفع عروة رأسه، فقال من هذا ؟ قالوا المغيرة بن شعبة فقال أي غُدَرُ، ألستُ أسعى في غدرتك ؟ وكان المغيرة صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – «أما الإسلامَ فأقبلُ، وأما المال فلست منه في شيء» ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – بعينه قال فوالله ما تنخم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نخامة إلا وقعت في كفِّ رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وَضُوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له، فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكًا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمدٍ محمدًا، والله إن يَتَنَخَّمُ نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وَضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يُحِدُّون إليه النظر تعظيمًا له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، فقال رجل من بني كنانة دعوني آتيه فقالوا ائته فلما أشرف على النبي – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – «هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البُدْنَ فابعثوها له» فَبُعِثَتْ له، واستقبله الناس يُلَبُّونَ فلما رأى ذلك قال سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يُصَدُّوا عن البيت، فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قُلِّدَتْ وأشُعْرتْ، فما أرى أن يُصَدُّوا عن البيت، فقام رجل منهم يقال له مِكْرَزُ بن حفص، فقال دعوني آتيه، فقالوا ائْتِه، فلما أشرف عليهم قال النبي – صلى الله عليه وسلم – «هذا مكرز، وهو رجل فاجر، فجعل يكلم النبي – صلى الله عليه وسلم – فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرٍو قال مَعْمَرٌ فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيلٌ، قال النبي – صلى الله عليه وسلم – «قد سَهُلَ لكم من أمركم» قال معمرٌ قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكْتُبْ بيننا وبينكم كتابًا، فدعا النبي – صلى الله عليه وسلم – الكاتب، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – «بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيلٌ أما «الرحمن» فلا أدري ما هي، ولكن اكتب «باسمك اللهم» كما كنت تكتب، فقال المسلمون والله لا يكتبها إلا «بسم الله الرحمن الرحيم» فقال «اكتبْ باسمك اللهم» ثم قال «هذا ما قضى عليه محمد رسول الله»، فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – «والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتبْ محمد بن عبد الله» قال الزهري وذلك لقوله «لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» فقال له النبي – صلى الله عليه وسلم – :«على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به» فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضُغْطَةً، ولكن ذلك من العام المقبل، فكتب، فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجلٌ وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، قال المسلمون سبحان الله، كيف يُرَدَّ إلى المشركين، وقد جاء مسلمًا؟ فبينما هم كذلك، إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرٍو يرسف في قيوده، قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيلٌ هذا يا محمدُ أول ما أقاضيك، عليك أن ترده إليَّ فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – «إنا لم نقض الكتاب بعد» قال فوالله إذًا لا أصالحك على شيءٍ أبدًا قال النبي – صلى الله عليه وسلم – «فأجِزْهُ لي» قال ما أنا بمجيزه لك، قال «بلى فَافْعَلْ»، قال ما أنا بفاعل قال مكرز بل قد أجزناه لك قال أبو جندل أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلمًا؟ ألا ترون ما قد لقيتُ؟ وكان عُذّب عذابًا شديدًا في الله، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتيت نبي الله – صلى الله عليه وسلم – ، فقلت ألست نبيَّ الله حقًا؟ قال «بلى» قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال «بلى» قلت فَلِمَ نعطي الدنية في ديننا إذًا؟ قال «إني رسول الله، ولستُ أعصيه وهو ناصري» قلت أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال «بلى، فأخبرتك أنا نأتيه العام؟» قال قلت لا قال «فإنك آتيه ومُطَّوِّفٌ به» قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر، أليس هذا نبيَّ الله حقًا؟ قال بلى، قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال بلى قلت فَلِمَ نعطي الدنية في ديننا إذًا؟ قال أيها الرجل، إنه لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – ، وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاسْتمْسِكْ بغرزه، فوالله إنه على الحق، قلت أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال بلى، أفأخبرك أنك تأتيه العامَ ؟ قلت لا، قال فإنك آتيه ومُطَّوِّفٌ به
قال الزهري قال عمر رضي الله عنه فعملت لذلك أعمالاً، قال فلما فرغ من قضية الكتاب، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لأصحابه «قوموا فانحروا ثم احلقوا» قال فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما يقم منهم أحد، ثم دخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة يا نبي الله، أتحب ذلك ؟ اخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بُدْنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدْنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك، قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضًا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًا، ثم جاءه نسوة مؤمنات، فأنزل الله تعالى[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ حتى بلغ بِعِصَمِ الكَوَافِر]ِ الممتحنةّ- 10 ] فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، والأخرى صفوان بن أمية، ثم رجع النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش، وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا العهدَ الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجل، فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تَمْرٍ لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدًا، فاستله الآخر فقال أَجَلْ والله إنه لجيد، لقد جربتُ به، ثم جربت به، ثم جربت، فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، فأمكنه منه، فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حين رآه «لقد رأى هذا ذعرًا»، فلما انتهى إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – قال قُتِلَ والله صاحبي، وإني لمقتول، فجاء أبو بصير، فقال يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد ردتني إليه ثم أنجاني الله منهم، قال النبي – صلى الله عليه وسلم – «ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد» فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، قال وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – تناشده الله والرحمَ لما أرسل فمن أتاه فهو آمن، فأرسل النبي – صلى الله عليه وسلم – إليهم، فأنزل الله تعالى[ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ حتى بلغ الحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ ٍٍ] [الفتح -24: 26 ٍ]، وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينه وبين البيت.
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحروب وكتابة الشروط برقم(2731-2732)، وله أطراف ذكر فيها بعض الحديث مختصرًا مقتصرًا على بعضه، وذلك بالأرقام (1694-1695-1811-2711-2712 -2731-2732-4157-4158-4158-4178-4179 -4180- 4181) ،وأخرجه أبو داود في سننه برقم (1753) مقتصرًا على تقليد الهدي وإشعاره، كما أخرجه الإمام النسائي في السنن الكبرى في السير (162) مختصرًا، و(1: 2 ) كما في التحفة، وقد ساق القصة ابن إسحاق في السيرة بطولها بألفاظ مقاربة لألفاظ البخاري، كما نقلها عنه ابن هشام في السيرة
شرح الحديث
قال الحافظ في الفتح قوله «عن المسور بن مخرمة ومروان» أي ابن الحكم، «قالا خرج» هذه الرواية بالنسبة إلى مروان مرسلة لأنه لا صحبة له، وأما المسور فهي بالنسبة إليه أيضًا مرسلة لأنه لم يحضر القصة، وقد تقدم في أول الشروط من طريق أخرى عن الزهري عن عروة أنه سمع المسور ومروان يخبران عن أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فذكر بعض الحديث، وقد سمع المسور ومروان من جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة ؛ كعمر وعثمان وعلي والمغيرة وأم سلمة، وسهل بن حنيف وغيرهم، ووقع في نفس هذا الحديث شيء يدل على أنه عن عمر رضي الله عنه كما سيأتي التنبيه عليه وقد روى أبو الأسود عن عروة هذه القصة، فلم يذكر المسور ولا مروان لكن أرسلها، وهي كذلك في «مغازي عروة بن الزبير» أخرجها ابن عائذ في المغازي له بطولها، وأخرجها الحاكم في «الإكليل» من طريق أبي الأسود عن عروة أيضًا مقطعة
قوله «زمن الحديبية» في معجم البلدان الحديبية بضم الحاء وفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة مكسورة وياء خفيفة أو مشددة قرية متوسطة، سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – تحتها، بعضها في الحل وأكثرها في الحرم، وقيل سميت بشجرة حَدْبَاءَ صغرت.
قال الحافظ في الفتح ووقع في رواية ابن إسحاق في المغازي عن الزهري «خرج عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالاً» ووقع عند ابن سعد «أنه– صلى الله عليه وسلم – خرج يوم الاثنين لهلال ذي القعدة» قوله «حتى إذا كانوا ببعض الطريق» قال ابن حجر اختصر المصنف صدر هذا الحديث الطويل مع أنه لم يسقه بطوله إلا في هذا الموضع، وبقيته عنده في المغازي من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري قال ونبأنيه معمر عن الزهري وسار النبي – صلى الله عليه وسلم – حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه فقال إن قريشًا جمعوا جموعًا، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك، فقال – صلى الله عليه وسلم – :أشيروا أيها الناس عليَّ، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت، فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عيناً من المشركين، وإلا تركناهم محرومين، قال أبو بكر يا رسول الله، خرجت عامدًا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه قال امضوا على اسم الله.
إلى ها هنا ساق البخاري في المغازي من هذا الوجه، وزاد أحمد عن عبد الرزاق، وساقه ابن حبان من طريقه قال قال معمر قال الزهري وكان أبو هريرة يقول ما رأيت أحدًا قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – اهـ.
ثم ذكر ابن حجر الروايات التي تؤكد مشاورة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لأصحابه، ورد أبي بكر عليه إشارته بالاستمرار إلى ما جاء من أجله وهو العمرة حتى يكون بدء القتال من المشركين، وأخذ النبي – صلى الله عليه وسلم – برأي أبي بكر رضي الله عنه قال: والأحابيش جمع أُحْبُوشٍ، وهم بنو الهون بن خزيمة بن مدركة، وبنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة، وبنو المصطلق من خزاعة كانوا تحالفوا مع قريش قيل تحت جبل يقال له الحبشى أسفل مكة، وقيل سموا بذلك لتحبشهم، أي تجمعهم، والتحبش التجمع، والحباشة الجماعة.
قوله «قال النبي – صلى الله عليه وسلم – إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة» خالد لم يكن أسلم حينئذ، وإنما كان على شركه فلم يسلم إلا بعد الحديبية، وأما الغميم فبفتح المعجمة وحكى فيها القاضي عياض الضم على التصغير.
قال المحب الطبري يظهر أن المراد كراع الغميم وهو موضع بين مكة والمدينة اهـ .
قال ابن حجر وسياق الحديث ظاهر في أنه كان قريبًا من الحديبية، فهو غير كراع الغميم الذي وقع ذكره في الصيام وهو الذي بين مكة والمدينة، وأما الغميم هذا فقال ابن حبيب هو قريب من مكان بين رابغ والجحفة، وبين ابن سعد أن خالداً كان في مائتي فارس فيهم عكرمة بن أبي جهل، والطليعة مقدمة الجيش.
قوله «فخذوا ذات اليمين» أي الطريق التي فيها خالد.
قوله «حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرًا لقريش» القَتَرَةُ الغبار الأسود، فانطلق، أي خالد بن الوليد لينذر قريشًا.
قوله «وسار النبي حتى إذا كان بالثنية» في رواية ابن إسحاق في السيرة «فقال من يخرجنا على طريق غير طريقهم التي هم بها ؟ قال فحدَّثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رجلاً من أسلم قال أنا يا رسول الله، فسلك بهم طريقًا وعرًا، فأخرجوا منها بعد أن شق عليهم، وأمضوا إلى أرض سهلة، فقال لهم استغفروا الله ففعلوا فقال والذي نفسي بيده إنها لَلْحِطَّةُ التي عُرِضَتْ على بني إسرائيل فامتنعوا».
قوله «بركتْ به راحلته، فقال الناس حَلْ حَلْ» حَلْ حَلْ كلمة تقال للناقة إذا تركت السير لتحثها عليه، وقال الخطابي إن قلتَ حلْ واحدة فالسكون، وإن أعدتها نونت الأولى وسكنت في الثانية، وحكى غيره السكون فيهما والتنوين أيضًا كنظيره في بخ بخ
قوله «فألَحَّتْ» أي لزمت المكان وتمادت في عدم القيام، وهو من الإلحاح
قوله «خلأت القصواء» الخَلاءُ للإبل كالحِرانِ للخيل، والقصواء اسم ناقة النبي ، وكانت مَقْصُوَّةَ الأُذُنِ، وهو قطع طرف من الأذن، فيقال ناقة قصواء أي مقصوُّة، جاء بلفظ الفاعل، ومعناه المفعول، ولم يقولوا جمل أقصى
قوله «وما ذاك لها بخلق» أي ليس ذلك عادة لها فيما مضى
قوله «حبسها حابس الفيل» أي حبسها الله تعالى عن دخول مكة، كما حبس الفيل عنها، حين جاء به أبرهة الحبشي يريد هدم الكعبة واستباحة الحرم، قال الخطابي والمعنى في ذلك والله أعلم أنهم لو استباحوا مكة لأتى القتل على قوم في علم الله أنهم سيسلمون، أو سيخرج من أصلابهم ذرية مؤمنون قال فهذا موضع التشبيه لحبسها بحبس الفيل قال الحافظ في الفتح وكان بمكة عام الحديبية جمع كثير مؤمنون من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فلو طرق الصحابة أي دخلوها لما أمن أن يصاب ناس منهم بغير عمد كما أشار إليه قوله تعالى «وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ» الآية
قوله «والذي نفسي بيده» فيه تأكيد القول باليمين فيكون أدعى للقبول، قال ابن القيم في «الزاد» وقد حفظ عن النبي الحَلِفُ في أكثر من ثمانين موضعًا والله أعلم
قوله «لا يسألوني خطة» بضم الخاء أي خصلة «يعظمون فيها حرمات الله» أي من ترك القتال في الحرم، وفي رواية ابن إسحاق «لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها» قال الحافظ وهي من جملة حرمات الله، وقيل المراد بالحرمات حرمة الشهر وحرمة الحرم والإحرام، قال وفي الثالث نظر لأنهم لو عظموا الإحرام ما صدوه
قوله «إلا أعطيتهم إياها» أي أجبتهم إليها، قال السهيلي لم يقع في شيء من طرق الحديث أنه قال إن شاء الله، مع أنه مأمور بها في كل حال، والجواب أنه كان أمرًا واجبًا حتمًا فلا يحتاج فيه إلى الاستثناء كذا قال وتعقب بأنه تعالى قال في هذه القصة «لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ» فقال «إن شاء الله» مع تحقق وقوع ذلك تعليمًا وإرشادًا، فالأولى أن يحمل على أن الاستثناء سقط من الراوي قلت أو من الناسخ أو كانت القصة قبل نزول الأمر بذلك، ولا يعارضه كون الكهف مكية إذ لا مانع أن يتأخر نزول بعض السورة
قوله «ثم زجرها» أي الناقة، «فوثبت» أي قامت
قوله «فعدل عنهم» في رواية ابن سعد «فولى راجعًا»، وفي رواية ابن إسحاق «ثم قال للناس انزلوا؛ قيل له يا رسول الله، ما بالوادي ماء، فننزل عليه»
قوله «على ثَمَدٍ» أي حفيرة فيها ماءٌ مَثْمُودٌ، أي قليل، وقوله «قليل الماء»، تأكيد لدفع توهم أن يراد لغة من يقول إن الثمد الماء الكثير، وقيل الثمد ما يظهر من الماء في الشتاء ويذهب في الصيف
قوله «يَتَبَرَّضُهُ الناس» التَّبَرُّضُ هو الأخذ قليلاً قليلاً، والبرض بفتح الراء وسكونه اليسير من العطاء وذكر أبو الأسود في روايته عن عروة «وسبقت قريش إلى الماء فنزلوا عليه ونزل النبي الحديبية في حر شديد وليس بها إلا بئر واحدة»
قوله «فلم يُلْبِثْهُ» من الإلباث، وقال ابن التين بفتح اللام وكسر الموحدة الثقيلة ؛ أي لم يتركوه يلبث أي يقيم
قوله «فانتزع سهمًا من كنانته» أي أخرج سهمًا من جعبته
قوله «ثم أمرهم» في رواية ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن رجال من أسلم أن الذي نزل في القليب بسهم رسول الله ناجية بن جندب وهو سائق بدن رسول الله ، قال ابن إسحاق وقد زعم لي بعض أهل العلم أن البراء بن عازب كان يقول أنا الذي نزلت بسهم رسول الله ، قال الحافظ وروى الواقدي من طريق خالد بن عبادة الغفاري قال «أنا الذي نزلت بالسهم» ويمكن الجمع بأنهم تعاونوا على ذلك بالحفر وغيره وعند المصنف من حديث البراء بن عازب في المغازي أنه جلس على البئر ثم دعا بإناء فمضمض ودعا الله ثم صبه فيها، ثم قال «دعوها ساعة»، ثم إنهم ارتووا بعد ذلك قال الحافظ ويمكن الجمع بأن يكون الأمران معًا وقعا
قوله «يَجِيشُ» أي يفور، وقوله «بالرِّي» بكسر الراء ويجوز فتحها، وقوله «صدروا عنه» أي رجعوا رواة بعد أن وردوا زاد ابن سعد «حتى اغترفوا بآنيتهم جلوسًا على شفير البئر»
قوله «إذا جاء بُدَيْلُ بن وَرْقاء» أما بُدَيل فبصيغة التصغير، وورقاء بفتح الواو وسكون الراء والقاف المفتوحة بعدها ألف ممدودة صحابي مشهور
قوله «في نفر من قومه» قال الحافظ سمى الواقدي منهم عمرو بن سالم وخراش بن أمية وفي رواية أبي الأسود عن عروة منهم خارجة بن كرز وزياد بن أمية
قوله «وكانوا عَيْبَةَ نُصْح» العَيْبَةُ ما توضع فيه الثياب لحفظها، أي أنهم موضع النصح له والأمانة على سره، وقوله «من أهل تهامة» تِهَامَةُ هي مكة وما حولها، وأصلها من التهم، وهو شدة الحر وركود الريح، وخزاعة كانوا من جملة أهل تهامة
قوله «إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي» قال الحافظ إنما اقتصر على هذين لكون قريش الذين كانوا بمكة أجمع ترجع أنسابهم إليهما قال وقد وقع في رواية أبي المليح «وجمعوا لك الأحابيش» من التحبش وهو التجمع
قوله «نزلوا أعداد مياه الحديبية» الأَعْدَادُ جمع العِدِّ، وهو الماء الدائم الذي لا ينقطع قال الحافظ وقول بُدَيْلٍ هذا يشعر أنه كان بالحديبية مياهٌ كثيرة وأن قريشًا سبقوا إلى النزول عليها، فلهذا عطش المسلمون حيث نزلوا على الثمد المذكور قوله «ومعهم العُوذُ المطافيل» العُوْذُ جمع عائذ وهي الناقة ذات اللبن، والمطافيل الأمهات اللاتي معها أطفالها، يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه، أو المراد أنهم خرجوا معهم بنسائهم وأطفالهم لإرادة طول المقام وليكون أدعى إلى عدم الفرار، ويحتمل إرادة المعنى الأعم
قوله «نَهِكَتْهُم الحرب» أي أبلغت فيهم حتى أضعفتهم، أي أضعفت قوتهم وأموالهم
قوله «ماددتهم» أي جعلت بيني وبينهم مُدَّةً بترك الحرب بيننا وبينهم فيها
قوله «فإن أظهر وإن شاءوا» شرط بعد شرط، وتقدير الكلام فإن ظهر غيرهم عليَّ كفاهم المؤنة، وإن أظهر أنا على غيرهم فإن شاءوا أطاعوني وإلا فلا تنقضي مدة الصلح إلا وقد جَمُّوا أي استراحوا ووقع في رواية ابن إسحاق «وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» وإنما ردد الأمر مع أنه جازم بأن الله تعالى سينصره ويظهره لوعد الله تعالى له بذلك، على طريق التنزل مع الخصم وفرض الأمر على ما زعم الخصم
قوله «حتى تنفرد سالفتي» السَّالِفَةُ صفحة العنق، وكنى بذلك عن القتل ؛ لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه قوله «ولينفذن الله أمره» أي ليمضين الله أمره في نصر دينه قال الحافظ وحسن الإتيان بهذا الجزم بعد ذلك التردد للتنبيه على أنه لم يورده إلا على سبيل الفرض
قوله «فقال بُدَيْلٌ سأبلغهم ما تقول» أي فأذن له قوله «فحدثهم بما قال» زاد ابن إسحاق في روايته فقال لهم بديلٌ ومن معه يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد، إن محمدًا لم يأت لقتال، إنما جاء زائرًا هذا البيت، فاتهموهم، وقالوا وإن كان جاء ولا يريد قتالاً، فوالله لا يدخلها علينا عَنْوَةً أبدًا، ولا تَحَدَّثُ بذلك العرب عنا
قوله «فقام عروة بن مسعود بن مُعَتِّب الثقفي» ووقع في رواية ابن إسحاق عند أحمد عروة بن عمرو، والصواب الأول وهو الذي وقع في السيرة .
قوله «ألستم بالوالد وألستُ بالولد ؟ قالوا بلى» كذا لغير أبي ذر وهو الصواب وهو الذي في رواية أحمد وابن إسحاق وغيرهما ولأبي ذر بالعكس «ألستم بالولد وألست بالوالد؟» وقد كانت أم عروة هي سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف، فأراد بقوله «ألستم بالوالد، أنكم حي قد ولدتموني في الجملة لكون أمي منكم» قال الحافظ وجرى بعض الشراح على ما وقع في رواية أبي ذر، فقال أراد بقوله «ألستم بالولد» أي أنتم عندي في الشفقة والنصح بمنزلة الولد، قال ولعله كان يخاطب بذلك قومًا هو أسن منهم
قوله «فلما بَلَّحُوا» أي امتنعوا والتبلح التمنع من الإجابة
قوله «قد عرض عليكم خُطَّة رُشْدٍ» في رواية الكشميهني عرض لكم، والخُطَّةُ بضم الخاء وتشديد الطاء، والرُّشْد بضم الراء وسكون الشين وبفتحهما أي قد عرض عليكم أو لكم خصلة خير وإنصاف، ولقد بين ابن إسحاق أن سبب تقديم عروة بن مسعود لهذا الكلام عند قريش ما رآه من ردهم العنيف على من يجيء من عند المسلمين
قوله «دعوني آتِهِ» بالمد مجزوم جوابًا للأمر، أي أجيء إليه، «قالوا ائته» بهمزة وصل بعدها همزة قطع
قوله «اجتاح» أي أهلك أهله بالكلية، وحذف الجزاء من قوله «وإن تكن الأخرى» تأدبًا مع النبي ، والمعنى وإن تكن الغلبة لقريش لا آمنهم عليك وقوله «فإني والله لأرى وجوهًا» إلخ كالتعليل للقدر المحذوف، ومقتضى كلام عروة أنه رَدَّدَ الأمر بين شيئين غير مستحسنين وهما هلاك قومه إن غَلَبَ، وذهاب أصحابه إن غُلِبَ لكن الأمرين مستحسنين شرعًا كما قال تعالى «قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ»
قوله «أشْوَابًا» بتقديم الشين على الواو، كذا للأكثر، ووقع لأبي ذر عن الكشميهني «أوشابًا» بتقديم الواو فالأشواب الأخلاط من أنواع شتى، والأوْشاب والأوْباش الأخلاط من السفلة، فالأوباش أخص من الأشواب قوله «خليقًا» أي حقيقًا وزنًا ومعنىً، ويقال للواحد والجمع، ولذلك وقع صفة لأشواب
قوله «ويَدَعوك» أي يتركوك، وفي رواية أبي المليح عن الزهري «وكأني بهم لو قد لقيت قريشًا قد أسلموك فتؤخذ أسيرًا فأي شيء أشد عليك من ذلك»
قوله «فقال له أبو بكر الصديق» قال الحافظ زاد ابن إسحاق «وأبو بكر الصديق خلف رسول الله قاعد فقال»
قوله «امصص بظر اللات» قال الحافظ زاد ابن عائذ من وجه آخر عن الزهري «وهي أي اللات طاغيته التي يعبد» أي طاغية عروة وقوله امْصَصْ بألف وصل وصادين الأولى مفتوحة ؛ بصيغة الأمر، قال في لسان العرب وهو الفصيح الجيد، وفي القاموس امْصُصْ ؛ بضم الأولى، فالصيغة الأولى من مَصِصَ يَمْصَصُ، والثانية من مَصَصَ يَمْصُصُ والبَظْرُ قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة، واللات اسم أحد الأصنام التي كانت قريش وثقيف يعيدونها، وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ الأم، فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة معبوده مقام أمه وحمله على ذلك ما أغضبه من نسبة المسلمين إلى الفرار
قوله «لولا يد» أي نعمة، وقوله «لم أجزك بها» أي لم أكافئك بها، زاد ابن إسحاق «ولكن هذه بها» أي جازاه بعدم إجابته عن شتمه بيده التي كان أحسن إليه بها، وبين عبد العزيز الإمامي عن الزهري في هذا الحديث أن اليد المذكورة أن عروة كان تحمل بدية فأعانه أبو بكر فيها بعون حسن، وفي رواية الواقدي عشر قلائص
قوله «فكلما كلمه أخذ بلحيته» وفي رواية ابن إسحاق «فجعل يتناول لحية النبي وهو يكلمه»
قوله «والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي ومعه السيف» في مغازي عروة بن الزبير رواية أبي الأسود عنه «أن المغيرة لما رأى عروة بن مسعود مقبلاً لبس لأمته وجعل على رأسه المغفر ليستخفي من عمه عروة»
قوله «بنعل السيف» هو ما يكون أسفل القراب من فضة وغيرها
قوله «أخر يدك» فعل أمر من التأخير، زاد ابن إسحاق في روايته «قبل ألا تصل إليك» وزاد عروة بن الزبير «فإنه لا ينبغي لمشرك أن يمسه»، وفي رواية ابن إسحاق «فيقول عروة ويحك ما أَفَظَّكَ وأَغْلَظَكَ، وكانت عادة العرب أن من كلم أحدًا تناول لحيته ولا سيما عند الملاطفة، وغالبًا ما يصنع ذلك النظير بنظيره» لكن النبي كان يغضي لعروة عن ذلك تأليفًا له واستمالة لقلبه، والمغيرة يمنعه إجلالاً للنبي وتعظيمًا
قوله «فقال من هذا ؟ قالوا المغيرة» وفي رواية ابن إسحاق فتبسم رسول الله، فقال عروة من هذا يا محمد ؟ قال «هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة» قال الحافظ وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من حديث المغيرة بن شعبة نفسه بإسناد صحيح، وأخرجه ابن حبان
قوله «أيْ غُدَرُ» وزن عمر معدول عن غادر مبالغة في وصفه بالغدر
قوله «أَلَسْتُ أسعى في غدرتك ؟» أي ألست أسعى في دفع شر غدرتك ؟ قال ابن هشام في السيرة أراد عروة بقوله هذا أن المغيرة قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلاً من بني مالك من ثقيف، فتهايج الحيان من ثقيف بنو مالك رهط المقتولين، والأحلاف رهط المغيرة، فودى عروة المقتولين ثلاث عشرة دية، وأصلح ذلك الأمر قال الحافظ وقد ساق ابن الكلبي والواقدي القصة، وحاصلها أنهم كانوا خرجوا زائرين المقوقس بمصر، فأحسن إليهم وأعطاهم وقصر بالمغيرة فحصلت له الغيرة منهم، فلما كانوا بالطريق شربوا الخمر، فلما سكروا وناموا وثب المغيرة فقتلهم ولحق بالمدينة فأسلم
قوله «فجعل يرمُق» أي يلحظ
قوله «فدلك بها وجهه وجلده » إلخ قال الحافظ في الفتح ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة وبالغوا في ذلك إشارة منهم إلى الرد على ما خشيه من فرارهم، وكأنهم قالوا بلسان الحال من يحب إمامه هذه المحبة ويعظمه هذا التعظيم كيف يُظَنُّ به أنه يَفِرُّ عنه ويُسْلِمِه لعدوه ؟ بل هم أشد اغتباطًا به وبدينه وبنصره من القبائل التي يراعي بعضها بعضًا بمجرد الرحم
قوله «ووفدت على قيصر » إلخ هو من ذكر الخاص بعد العام، وذكر الثلاثة لكونهم أعظم ملوك ذاك الزمان، وفي مرسل علي بن زيد عند ابن أبي شيبة «فقال عروة أي قوم، إني قد رأيت الملوك، ما رأيت مثل محمد وما هو بملك، ولكن رأيت الهدي معكوفًا، وما أراكم إلا ستصيبكم قارعة، فانصرف هو ومن اتبعه إلى الطائف».